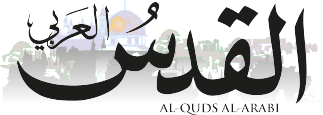لم تخطأ الفيلسوفة الألمانية حَنَّا أرندت عندما عَرَّفَت النظام الشمولي في كتابها “جذور الشمولية” كونه نظاما يحمل في جوهره ديناميكية لتدمير الواقع والتركيبة الاجتماعية وليس نظاما ساكنا ثابتا، هو الحال نفسه مع النظام الاستبدادي، والذي يختلف كونه لا يبحث عن تغيير قيم المجتمع قسرا وإعطاء نفسه بعدا يشمل الإنسانية كالنظام الشمولي كامل الأركان.
شمولية النظام الشيوعي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولاته اجترار شمولية النظام الشيوعي المنهار والعودة إلى الوراء تحت شعارات شعبوية قومية، أدخل روسيا أتون حرب خاسرة، ووضعها في مهب الريح، ما أدى إلى عزل بلاده عن العالم باستثناء بعض دول مشابهة، فمن كان حلفاؤه على شاكلة النظام الإيراني أو الكوري الشمالي هو حقا معزول.
أول هذه الهَبَّات كانت تلك التي أتت من صنيعة يده، المجموعة الإرهابية فاغنر ورئيسها بريغوجين وجنودها القادمون من السجون، والتي اضطر للإعلان رسميا عن تبعيتها الكاملة لنظامه، بعد أن استعملها لسنوات طويلة لضرب ثورات العالم وسرقة ثرواتها، خصوصا الذهب، من مالي إلى السودان، مرورا في سوريا وليبيا.
طبيعة النظام لم تعد تخفيها ورقة التوت الرقيقة التي كان يحملها. عليه الآن مواجهة واقع جديد، فهو لم يعد قادرا على السيطرة على أقرب المقربين.
وسيستنتج الكثير من الدول التي كانت تثق بالرئيس الروسي مدى فقدانه للمصداقية ومدى هشاشة نظامه، وعلينا أن نراقب في الأسابيع المقبلة التحول الممكن في آراء ومواقف دول مهمة مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، والتي كان يدعي بوتين أنها شركاؤه لخلق عالمه الجديد.
بنى الرئيس الروسي نظامه كباقي الأنظمة المستبدة على مبدأ أنه يحمي الشعب من نفسه، بمعنى أن انهيار النظام سيؤدي حتما إلى حرب أهلية وما إليه، هذه الأسطوانة نسمعها دائما أمام أي احتجاج، ويبرر استعمال كل وسائل العنف، كأن الشعب بطبيعته سيئ، ولا ينتظر إلا لحظة أن يحرق نفسه بنفسه.
الواقع يبين العكس فالذي دمر الشعب الإيراني هو نظامه، كذلك الأمر بالنسبة لفنزويلا مع الرئيس مادورو والذي هَجَّر خمسة ملايين مواطن حفاظا على ثورته البوليفارية، وأفقَرَ بلدا غنيا بثرواته النفطية، يمكن ذكر ذلك أيضا مع كوبا كاسترو أو عراق صدام حسين، والذين ظنوا أن وجودهم هو ضمانة التقدم والازدهار، بينما نتائج سياساتهم الكارثية لا تخفى على أحد.
نظام بوتين يسير في الطريق نفسه متحججا بحماية روسيا وشعبها من الناتو والغرب، بينما تسبب هو بحربه على أوكرانيا بمقتل عشرات آلاف الجنود الروس وجرح مئات الآلاف، دون ذكر استهداف المدنيين دون تمييز كما فعل في سوريا. كذلك هرب حوالي مليون شاب روسي من المتعلمين لدول أجنبية خوفا من التجنيد والبحث عن حياة أفضل، بالإضافة للحصار الاقتصادي الخانق.
الخطر الحقيقي
السير نحو دمار روسيا هو ما سيحصده الشعب الروسي، تماما كما وصفت حَنَّا أرندت هكذا نظام في كتابها عام 1951. الخطر الحقيقي على روسيا كما قاله اليكسي نافالني من داخل سجنه هو بوتين وليس أي شيء آخر.
للأسف لا نرى أي بادرة من طرف الشعب الروسي للتحرك في اتجاه الخلاص. فقد أقنعهم أن وجوده في السلطة هي ضرورة قصوى لحمايتهم من شياطين الغرب وانحلاله الخلقي، تماما كما أقنع زعيم كوريا الشمالية شعبه، والذي يعتقد حقا أنه يعيش داخل حدود الجَنَّة الكورية الشمالية، بينما العالم أجمع يعيش في الجحيم، رغم أنهم يموتون جوعا في جنته النووية.
هل ستتحول روسيا إلى جنَّة كورية أخرى، هذا ممكن جدا، فهذه الأنظمة إن لم تنهار تؤدي دائما إلى الدمار والخراب..
نحن العرب لنا عبرة بما حدث ويحدث في بلادنا، يكفي أن ننظر إلى السودان الآن أو سوريا وليبيا، وكيف قام الرئيس الروسي بجيشه وميليشياته بتدمير وسرقة دولنا، لنتأكد من أن هؤلاء الذين ما زالوا يدعمون بوتين ونظامه، لم ينظروا إلى أنفسهم وأوطانهم أولا.
كاتب فلسطيني